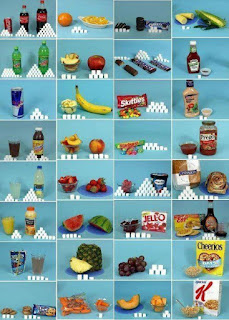باحثة ألمانية تدعى "ماريا
إليزابيث باومان" ذكرت في كتاب لها صدر قبل سنوات قليلة بعنوان: طرق النساء
المؤدية إلى الإسلام، بأن قرابة 250 إلى 300 ألمانية تعتنق الإسلام كل عام.. القصة ذاتها تتكرر في كثير
من أقطار العالم، لاسيما المتقدم منه، فتجد أن الداخلين الى الإسلام، أغلبهم من
طبقات مثقفة وذات وضع اجتماعي واقتصادي جيد غير بائس، الأمر الذي أثار كثيراً من
الباحثين والدارسين في الغرب، وجعلهم يتتبعون الأسباب التي تؤدي بفئات مثقفة واعية
لتغيير دينها أو معتقدها، والدخول في أكثر دين يواجه حملات تشويه في العالم!
باحثة ألمانية تدعى "ماريا
إليزابيث باومان" ذكرت في كتاب لها صدر قبل سنوات قليلة بعنوان: طرق النساء
المؤدية إلى الإسلام، بأن قرابة 250 إلى 300 ألمانية تعتنق الإسلام كل عام.. القصة ذاتها تتكرر في كثير
من أقطار العالم، لاسيما المتقدم منه، فتجد أن الداخلين الى الإسلام، أغلبهم من
طبقات مثقفة وذات وضع اجتماعي واقتصادي جيد غير بائس، الأمر الذي أثار كثيراً من
الباحثين والدارسين في الغرب، وجعلهم يتتبعون الأسباب التي تؤدي بفئات مثقفة واعية
لتغيير دينها أو معتقدها، والدخول في أكثر دين يواجه حملات تشويه في العالم!
واحدة من الإجابات المبهرة
التي طُرحت من قبل الألمانيات، وسبب دخولهن الإسلام دون سائر الأديان الأخرى المعروفة
في العالم حالياً، هي أن الرغبة في تغيير نمط حياتهن من خلال بناء نظام أخلاقي جديد، أحد
الأسباب الرئيسية لاعتناق الإسلام، فيما عبّرت أخريات بأن سبب التحول للإسلام هو
الرغبة في هجرة رمزية، بحثاً عن انتماء مغاير بعيداً عن الوطن والعرق الألماني،
والذي وجدوه واضحاً في الإسلام.
 هذا الأمر يذكرنا بما كان
عليه الصحابي الجليل سلمان الفارسي قبل ظهور الإسلام، وقصة الهجرة والبحث عن
انتماء جديد يجد نفسه فيه.. فقد كان أبوه أحد الدهاقنة في مملكة كسرى، المسؤولين
على إبقاء جذوة النار متقدة في معابد المجوس، عبدة النار. وقد حرص أبوه على أن
يكون ولده وارثه في هذا الأمر، وهو ما لم يعجب سلمان، الذي ظل يبحث عن عقيدة أخرى
تطمئن إليه نفسه. فظل متنقلاً من مدينة إلى أخرى، ومن دين الى دين.. فتحول من
المجوسية الى النصرانية ثم اليهودية، حتى سمع من أحد الرهبان بأن وقت خروج نبي آخر
الزمان قد أزف، فانتظر سلمان الفارسي سنوات حتى مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى يثرب، ووجد أخيراً الدين الذي بحث عنه طويلاً، فاستقرت نفسه وصار من شخصيات
هذا الدين العظيم.
هذا الأمر يذكرنا بما كان
عليه الصحابي الجليل سلمان الفارسي قبل ظهور الإسلام، وقصة الهجرة والبحث عن
انتماء جديد يجد نفسه فيه.. فقد كان أبوه أحد الدهاقنة في مملكة كسرى، المسؤولين
على إبقاء جذوة النار متقدة في معابد المجوس، عبدة النار. وقد حرص أبوه على أن
يكون ولده وارثه في هذا الأمر، وهو ما لم يعجب سلمان، الذي ظل يبحث عن عقيدة أخرى
تطمئن إليه نفسه. فظل متنقلاً من مدينة إلى أخرى، ومن دين الى دين.. فتحول من
المجوسية الى النصرانية ثم اليهودية، حتى سمع من أحد الرهبان بأن وقت خروج نبي آخر
الزمان قد أزف، فانتظر سلمان الفارسي سنوات حتى مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى يثرب، ووجد أخيراً الدين الذي بحث عنه طويلاً، فاستقرت نفسه وصار من شخصيات
هذا الدين العظيم.
ما يحدث اليوم في الولايات المتحدة، دفع
بالآلاف للبحث عن سر هذا العداء المفتعل ضد هذا الدين. وإني لأحسبُ السحر بدأ
ينقلب على الساحر، أو كاد أن يكون كذلك. ويبدو أن الأمريكان على خطى الألمان
سائرون باحثون عما تطمئن إليه نفوسهم، كما كان مع سلمان وغيره كثير، وسيجدونه في
الإسلام بإذن الله..
والله متمٌ نوره ولو كره الكافرون.